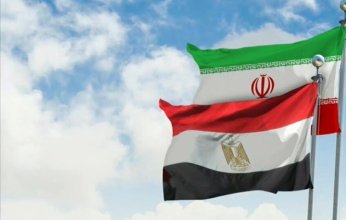مناقشة بيريه صوف أخضر لهايدي فاروق بالنقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا

برعاية دكتور علاء عبد الهادي
رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب
أقامت النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة البحيري ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية ( بيريه صوف أخضر) للقاصة والصحفية بمجلة صباح الخير هايدي فاروق
شارك فيها الشاعر والناقد الدكتور محمد عبد الله الخولي والدكتور والناقد أحمد كرماني والدكتورة ابتسام السيد..
وإدار الندوة الدكتور أسامة البحيري
وحضرها كوكبة من المبدعين والمبدعات والنقاد من بينهم الأستاذ الدكتور ماهر خليل
الدكتور كمال القدح
الدكتور صلاح الحبال والقاص حسين منصور..
والروائي فخري أبوشليب
والقاص والروائي عادل احمد البدوي
وقد عقدت الندوة بمقر النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا بطنطا.
في البداية أكد الدكتور أسامة البحيري أن النقابة تحرص على تتنوّع الأجناس الأدبية، إذ يميل الناس، بطبعهم، إلى مذاهب مختلفة في ما يعشقون من فنون الأدب.
ومن هذا المنطلق، تحرص نقابة الغربية على تقديم شتى صنوف الإبداع: من الشعر العامي والفصيح، إلى الرواية، والقصة القصيرة.
وقال: يسعدنا أن نناقش مجموعة قصصية مميزة لكاتبة صاعدة وواعدة، صدر لها مجموعتان قصصيتان، الأولى بعنوان امرأة البدايات، والثانية بيريه صوف أخضر، .
ومن يتأمل المجموعتين، سيلحظ انشغال الكاتبة بالهمّ النسوي، لا من باب الصدام مع الرجل، بل في إطار التماس مع المجتمع، وتقاليده، وموروثاته الثقافية.
مشيرا إلى تنوّع النصوص في هذه المجموعة، مثمّنا المقاطع المأخوذة من الأدب العالمي والعربي، والتي تتوشّح بها بدايات بعض القصص، وكذلك تأثر الكاتبة بأدب الرحلات، الذي يبدو أنها مولعة به، ما يُضفي على قصصها روحًا مختلفة، ويُحلّق بها في فضاءات سردية رحبة.
وقال الناقد الدكتور أحمد كرماني
عن مجموعة "بيريه صوف" تتجلى الذات الأنثوية بوصفها كيانًا هشًّا يتقاطع فيه التشكّل الوجودي مع حساسية الوعي، وتتمازج فيه الأنوثة مع تأملات الكينونة في عالم لا يكفّ عن التبدد والتشظي. تحتل رمزية "البيريه" موقعًا تأويليًّا بوصفه غطاءً للرأس، يحيل إلى مفاهيم الانضباط أو الهوية الثقافية، في حين يعبّر "الصوف" عن ملمس دافئ سرعان ما يتهرأ، ليصبح مرآة رمزية لهشاشة الذات وقدرتها على الاحتواء والانفلات في آنٍ معًا. تمارس الكاتبة، من خلال هذا العنوان المركّب، كتابة رمزية تشي برغبة دفينة في إعادة رسم حدود الأنا في مواجهة ما هو لا مرئي، لا عقلاني، ولا قابل للإدراك المألوف.

الذات السردية هنا لا تُقَدَّم كمركز مغلق أو هوية مكتملة، بل بوصفها كيانًا في طور التشكّل، يصطدم بالعالم لا ليعلن امتلاكه، بل ليفكك علاقته به، ويعيد مساءلة أدوات تمثيله وإدراكه. يظهر هذا الاشتباك في نصوص المجموعة من خلال تنويعات سردية دقيقة.. .مقدما دراسة نقدية بعنوان ( شروخ الأنوثة وتحولات السرد ) يتجلّى المكان بوصفه عنصرًا ديناميًّا لا ثابتًا، يشهد تحوّلات جوهرية توازي التحولات النفسية والوجودية للشخصيات. فالمكان ليس محايدًا، بل مرآة داخلية للمأساة، يتكثّف فيه القلق، ويتجلّى الحنين، وتتكوّن عبره علاقات الذات بالعالم، لا بوصفه فضاءً فيزيائيًا، بل كحامل للدلالة والتمزق والمحو.
منذ القصة الأولى “هكذا رأيت”، يُبنى المكان حول المقعد الخشبي، وهو في الظاهر مجرد قطعة أثاث، لكنه يتحوّل تدريجيًّا إلى بؤرة مكانية يتجمّع فيها الخوف والذاكرة والغياب. بيت الطفلة لا يُروى بوصفه مكانًا عاديًّا، بل كحيّز محفوف بالصمت والصوت الغامض والظلّ الثقيل للأب الراحل. المقعد في الركن الأيمن من الغرفة يصير مركزًا للبنية السردية، ومُستودعًا لتحوّلات الزمن والمأساة. المكان هنا يُجسّد التحوّل من الألفة إلى الرعب، من العائلة إلى العدم، من الطفولة إلى النضج القَلِق. وكما يعبّر لوكاتش، فإن المكان في النص العظيم لا يكون حيادًا بل يُعاد إنتاجه كجزء من الصراع بين الذات والعالم.
يتصاعد هذا التوظيف الرمزي للمكان في قصة “ساعة شيطان”، حيث يبدو المنزل للوهلة الأولى مأوىً أموميًّا، لكنه يتحوّل تدريجيًّا إلى حيّز قمعي، محكوم بالصمت، مُثقل بتكرار يومي خانق. النوافذ، الممرات، الغرف، كلها تُرسم بلغة جافة تُحاكي جفاف العلاقة بين الأم وطفليها. البيت، الذي يُفترض أن يكون “دفءً”، ينقلب إلى معمار مغلق، يُعبّر عن انسداد عاطفي. فلا الجدران تُنقذ، ولا العتبات تُفضي إلى معنى. مأساة أم مع متوحدين في الخامس عشر من عمرهما، وهنا يتحوّل المكان إلى بنية سردية موازية للمأساة النفسية، لا يحتضن الذات بل يُعيد تصدّعها حين تتعاطف هذه الانثى مع هذا الشاب الذي رأته نزيلا في إحدى السجون معاقبا في جريمة قتل، فتستبد بها الهواجز النفسية وتخشى ساعة شيطانية تتخلص فيها منهما إشفاقا عليهما من الحياة العصيبة التي تنظمها ومجتمع لا يرحم.
وقدَّمت الدكتورة ابتسام سيد أحمد،
مدرِّس بكلية الآداب - جامعة بنها،
رؤيةً نقديةً بعنوان: "قلق الذات وتحولات الزمن في (بيريه صوف أخضر)".
يتبدّى منذ البداية اهتمامُ الكاتبةِ بالتفاصيل الدقيقة والهامشية التي قد تبدو عابرةً لعين القارئ، لكنها تحمل قلقًا وجوديًّا عميقًا. فعبر نصوص مثل: "ساعة شيطان"، و*"هكذا رأيت"، و"ليلة العودة"*، ثم "في يوم لا نتذكره جميعًا"، تُعيد هايدي فاروق تفكيكَ بنيةِ الزمن النفسي للمرأة، وترصد ارتباكها بين ما كان وما سيكون، بين ما خُبِّئ قسرًا في الذاكرة وما طفا على سطح الوعي.
هكذا تبني الكاتبة فضاءاتٍ سرديةً مشبعةً بالأسى والحنين والانتظار، يشوبها لحظاتٌ من المواجهة العنيفة مع مركز الإقصاء الاجتماعي والوصم الطبقي الذي يُلاحق المرأة في أكثر لحظاتها هشاشة.
بيد أنّ المتن السردي، بما يحويه من معانٍ مفككة، يتبعثر في العلامة والعتبة الأولى للمجموعة القصصية "بيريه صوف أخضر". فهو ليس مجرد تسمية جمالية، بل هو علامة مفتاحية تُضيء الدخول إلى العالم السردي للكاتبة.
فـ"البيريه" بوصفها غطاءً للرأس، تُحيل إلى التمويه والتخفي، وربما التكيف الجبري مع الواقع، بينما يحمل الصوف الأخضر دلالة الحياة والاستمرار رغم الجفاف والقسوة. وكأن العنوان يُوجز رحلة الذات الأنثوية في مواجهة الانطفاء وسط واقعٍ يُحاصرها من كل جانب.
 وضمن هذا الإطار، تسعى هذه الورقة إلى الوقوف عند قلق الزمن النفسي، ذلك القلق الذي يعبث بالذات الأنثوية ويتحوّل إلى تجربةٍ شعوريةٍ متوترة. ويرتبط بالقلق الزمني عنصران لا غنى للزمن عنهما: سرد الذاكرة الماضوية، والهامش الاجتماعي للأنثى. فالأول يتصل بالذاكرة بوصفها المستودع المتصدر للألم والحزن وكثير من المواقف المختلطة، ووسيلة لإعادة تشكيل الهوية. أما الثاني، فيرتبط بتهميش المجتمع للمرأة واستبعادها.
وضمن هذا الإطار، تسعى هذه الورقة إلى الوقوف عند قلق الزمن النفسي، ذلك القلق الذي يعبث بالذات الأنثوية ويتحوّل إلى تجربةٍ شعوريةٍ متوترة. ويرتبط بالقلق الزمني عنصران لا غنى للزمن عنهما: سرد الذاكرة الماضوية، والهامش الاجتماعي للأنثى. فالأول يتصل بالذاكرة بوصفها المستودع المتصدر للألم والحزن وكثير من المواقف المختلطة، ووسيلة لإعادة تشكيل الهوية. أما الثاني، فيرتبط بتهميش المجتمع للمرأة واستبعادها.

أولًا: قلق الزمن النفسي وتشظّي الذات الأنثوية
عند الاقتراب من البنية الزمنية، نجد الزمن لا يسير على نسقٍ خطيٍّ تقليدي، بل يتّخذ شكلًا متصدعًا وقلقًا، حيث تتداخل الأزمنة، وتتراكم الذكريات، وتتشابك مع الحاضر، بما يعكس ما يُسمى بـ"الزمن الشعوري" أو "الزمن النفسي".
ويجدر بنا التفريق بين الزمن النفسي والزمن الطبيعي (الكرونولوجي)، فالأول نعيشه بمعزل عمّا هو خارجي، ويتطلب ممارسة قرائية وتأملية، أما الثاني فلا يحتاج لذلك، إذ هو وقتٌ حقيقيّ يُحسب بساعة الزمن.
فالإنسان يدرك الزمن من خلال الساعات والتقاويم التي اخترعها، لكنه -وهو يُنظّم حياته وفق هذا الزمن الموضوعي- يجد نفسه ضحية مفارقةٍ يشعر بها، إذ يعيش بين زمنٍ طبيعيٍّ مستمدٍّ من معطيات القياس والحساب، وزمنٍ نفسيٍّ منبثقٍ من المشاعر والأحاسيس والحالات الذهنية.
وهذان الزمنان، وإن بديا متباعدَين، فهما متداخلان في آنٍ معًا. ولا شك أن لكل إنسان زمنَه النفسيَّ الخاص، الذي يختلف بتعدد النفوس وتنوع إدراكها، وهو ما أطلق عليه جاك لاكان "الزمن الميتافيزيقي" أو "الزمن الشعوري".
في ختام هذه الرحلة القرائية عبر مجموعة "بيريه صوف أخضر"، تتبدّى لنا الذات الأنثوية بوصفها كيانًا مفعمًا بالقلق والتشظي، ذاتًا تتماهى مع الزمن لا لتعيشه، بل لتُقاومه، وتلتحف بالذاكرة لا لتسترجعها، بل لتُفككها وتُعيد تشكيلها في مواجهة واقعٍ ضاغطٍ لا يرحم.
لقد استطاعت هايدي فاروق أن تمنح الهامش صوتًا، والذاكرة نبضًا، والزمن وجعًا ممتدًّا بين ثنايا الحكايات.
وقدم الدكتور محمد الخولي دراسة نقدية عن المجموعة بعنوان
المتخيل الذاتي والتخييل المرجعي ورصد تحولات العالم
وقال:يتصدر المجموعة القصصية: "بيريه صوف أخضر" لــ هايدي فاروق العنوان، الذي ارتأيت فيه أحد أمرين دون أن أنتصف لأحدهما. الأول: ربما يكون العنوان محض اختيار إشهاري حيث يتم اختيار أحد العناوين الفرعية وتصعيده إلى أفق العنوان الأكبر للمجموعة تكهنا من الكاتب أن هذا العنوان ملفت لنظر القارئ دون غيره. الثاني: أن تكون هناك - بعد مطالعتك للمجموعة القصصية - وحدة جامعة تنطوي تحتها المجموعة القصصية في إطلاقها.
يتشكل العنوان من ثلاث مفردات: [بيريه/ صوف/ أخضر] فالأول يشير إلى الرأس ومحيطها، حيث تحتشد بهذه الرأس الرؤى التي من خلالها يستطيع القاص أن يفكك شفرات الواقع. أما "الصوف" بوصفه مقاوما للبرد، لاحتفاظه بدرجة الحرارة لأطول فترة ممكنه، نستطيع أن نحمله دلالة رمزية ليتحول الــ "بيريه" - من خلال جنسه الذي ينتمي إليه - إلى برزخ يحمي خصوصية الذات الإنسانية ويمنحها استقلالها الفكري، لتحتفظ الذات الإنسانية بكيانها الرئوي الذي يحاول أن يفكك شفرات العالم/ الواقع دون أن تنكشف رؤيته للعالم. أما مفردة "الأخضر" فهي تشير - وفق ما هو متلاحظ لدينا - إلى طبيعة الذات الإنسانية وشغفها بالحياة، ومع ما ينتاب هذه الذات من انكسارات تظل خضراء لتواجه هذا العالم، وكل هذه المعاني والحمولات الدلالية وجدناها منطرحة كمرجعيات نصية للمجموعة القصصية في عموميتها.
تتوزع هذه المجموعة القصصية - باختلاف أنماطها - على عدة محاور نستطيع من خلالها أن نستقرئ النص قراءة واعية تنصفه وتضعه في أفق التلقي الملائم له.
المرجع بين الواقع والتخييل:
الموضوع- بوصفه المحايث - منطرح في العالم بطبيعته الوجودية، ولكنه عند دخوله إلى العالم النصي يتعمّد بماء التخييل، هذا الأخير الذي يجعل الموضوع أكثر تجريدا وانفتاحا على العالم، حيث يتحول من كونه موضوعا مباشرا/ سطحيا إلى موضوع أعمق رؤية وأكثر استغوارا، وما وصل الموضوع النصي إلى هذه الدرجة من العمق إلا بالتخييل الذي من خلاله ترى الذات موضوعات العالم. في قصتها "هكذا رأيت" يتحول (الموت) بوصفه موضوعا نصيا إلى صوت يؤرق الذات ويقض مضجعها، ولا يصدر إلا من مساحة/ حيز/ شيء تنجذب إليه الذات وتعشقه ولا تجد راحتها إلا فيه.
من جانبها، وجّهت القاصة هايدي فاروق الشكر للنقابة الفرعية على ما تبذله من مجهودات ثقافية، سواء من خلال الأنشطة المختلفة، أو عبر صفحتها على "فيسبوك"، التي تؤدي دورًا مهمًّا في نشر الإبداع، ولا تقتصر على أعضاء اتحاد الكتّاب فقط، بل تحتفي بجميع المبدعين من مصر والوطن العربي. كما تسهم الصفحة في دعم فنون القصة القصيرة والشعر، وتُقدِّم دعمًا جادًّا للمواهب الأدبية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك